 |
| الرئيس بايدن واثق من أحدث سلاح أمريكي في "الحرب الاقتصادية" مع الصين. (المصدر: Shutterstock) |
ستفرض قواعد جديدة السيطرة على استثمارات القطاع الخاص في الخارج، وسيتم حظر الاستثمارات في أكثر التقنيات حساسية في الصين.
"ساحة صغيرة وسياج مرتفع"
وقالت مجلة الإيكونوميست إن استخدام مثل هذا التحفظ من جانب أقوى بطل للرأسمالية في العالم كان أحدث علامة على تحول عميق في السياسة الاقتصادية الأميركية في مواجهة صعود منافس أكثر حزما وتهديدا.
لعقود، ساندت الولايات المتحدة عولمة التجارة ورأس المال، مما حقق فوائد جمة من حيث زيادة الكفاءة وخفض التكاليف على المستهلكين. لكن في عالم محفوف بالمخاطر، لا تكفي الكفاءة وحدها.
في الولايات المتحدة وفي أنحاء الغرب، يُبرز صعود الصين أهدافًا أخرى. فمن المفهوم أن يسعى المسؤولون إلى حماية الأمن القومي من خلال الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة التي قد تُعزز قوتها العسكرية ، وبناء سلاسل إمداد بديلة في المناطق التي تُحكم فيها الصين قبضتها.
وكانت النتيجة سلسلة من التعريفات الجمركية ومراجعات الاستثمار وضوابط التصدير التي تستهدف الصين، أولاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والآن في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
في حين أن مثل هذه الإجراءات "لتخفيف المخاطر" قد تُقلل من فعاليتها، إلا أن الاستمرار في استخدام منتجات أكثر حساسية سيحد من الضرر. وستكون التكلفة الإضافية مُبررة، لأن أمريكا ستكون أكثر أمانًا.
تتضح تداعيات هذا التفكير الجديد. وللأسف، لا يوفر هذا المنطق المرونة أو الأمن. تزداد سلاسل التوريد تعقيدًا مع تكيفها مع القواعد الجديدة. وإذا دققنا النظر، يتضح أن اعتماد أمريكا على الصين في الحصول على المدخلات الأساسية لا يزال قائمًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه السياسة كان لها أثر عكسي، إذ دفعت حلفاء أمريكا إلى التقارب مع الصين.
قد يكون هذا مفاجئًا؛ للوهلة الأولى، تبدو السياسات الجديدة نجاحًا باهرًا. فالروابط الاقتصادية المباشرة بين الصين والولايات المتحدة آخذة في التقلص. في عام ٢٠١٨، استحوذت الصين على ثلثي واردات الولايات المتحدة من الدول الآسيوية "منخفضة التكلفة"، بينما استحوذت عليها في العام الماضي أكثر من النصف بقليل. وبدلًا من ذلك، اتجهت الولايات المتحدة نحو الهند والمكسيك وجنوب شرق آسيا.
تشهد تدفقات الاستثمار أيضًا تكيفًا. ففي عام ٢٠١٦، استثمرت الشركات الصينية مبلغًا مذهلًا قدره ٤٨ مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة. وبعد ست سنوات، انخفض هذا الرقم إلى ٣.١ مليار دولار أمريكي فقط. ولأول مرة منذ ٢٥ عامًا، لم تعد الصين من بين أهم ثلاث وجهات استثمارية لمعظم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في الصين. وعلى مدار العقدين الماضيين، استحوذت الصين على غالبية الاستثمارات الأجنبية الجديدة في آسيا. وفي عام ٢٠٢٢، تلقت الصين استثمارات أمريكية أقل من تلك التي تلقتها الهند.
لا يزال الاعتماد قائما
ولكن إذا تعمقنا أكثر، فسوف نجد أن اعتماد أميركا على الصين لا يزال قائما.
ربما تُحوّل الولايات المتحدة الطلب من الصين إلى دول أخرى. لكن التصنيع هناك يعتمد الآن على المُدخلات الصينية بشكل أكبر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، مع ازدياد صادرات جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، ازدهرت وارداتها من المُدخلات الوسيطة من الصين. تضاعفت صادرات الصين من قطع غيار السيارات إلى المكسيك، وهي دولة أخرى استفادت من تخفيف المخاطر الأمريكية، خلال السنوات الخمس الماضية.
تُظهر أبحاثٌ نشرها صندوق النقد الدولي أنه حتى في قطاعات التصنيع المتقدمة، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للابتعاد عن الصين، فإن الدول التي تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى السوق الأمريكية هي تلك التي تربطها أوثق الروابط الصناعية بالصين. وقد أصبحت سلاسل التوريد أكثر تعقيدًا، وارتفعت تكلفة التجارة. إلا أن هيمنة الصين لم تتضاءل.
ما الذي يجري؟
في الحالات الأكثر خطورة، تُعاد تعبئة البضائع الصينية ببساطة وتُرسل عبر دول ثالثة إلى الولايات المتحدة. في أواخر عام ٢٠٢٢، اكتشفت وزارة التجارة الأمريكية أن أربعة من كبار موردي الطاقة الشمسية في جنوب شرق آسيا كانوا يُجرون عمليات معالجة طفيفة على منتجات صينية أخرى؛ أي أنهم كانوا يتحايلون على الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية.
وفي مجالات أخرى، مثل المعادن الأرضية النادرة، تواصل الصين توفير المدخلات التي يصعب استبدالها.
لكن في أغلب الأحيان، تكون هذه الآلية حميدة. فالأسواق الحرة تتكيف ببساطة لإيجاد أرخص طريقة لتوصيل السلع إلى المستهلكين. وفي كثير من الحالات، تظل الصين، بقوتها العاملة الضخمة وخدماتها اللوجستية الفعّالة، المورد الأرخص.
من المرجح أن تُعيد القواعد الأمريكية الجديدة توجيه تجارتها مع الصين. لكنها لا تستطيع إبعاد سلاسل التوريد بأكملها عن النفوذ الصيني.
لذا، فإنّ جزءًا كبيرًا من "فك الارتباط" مُصطنع. والأسوأ من ذلك، من وجهة نظر السيد بايدن، أن نهجه يُعمّق أيضًا الروابط الاقتصادية بين الصين والدول المُصدّرة الأخرى، مُؤثّرًا في مصالحها ضدّ مصالح أمريكا. ورغم قلق الحكومات من تنامي نفوذ الصين، فإنّ علاقاتها التجارية مع أكبر اقتصاد في آسيا تتعمّق.
إن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) - وهي اتفاقية تجارية تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين العديد من دول جنوب شرق آسيا والصين - تخلق سوقًا واحدة على وجه التحديد للسلع الوسيطة التي ازدهرت تجارتها في السنوات الأخيرة.
بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة، يُعدّ تلقي الاستثمارات الصينية والسلع الوسيطة وتصدير السلع النهائية إلى الولايات المتحدة مصدرًا للوظائف والازدهار. ويُعدّ إحجام أمريكا عن دعم اتفاقيات تجارية جديدة أحد أسباب اعتبارها أحيانًا الولايات المتحدة شريكًا غير موثوق. فإذا ما خُيّرت بين الصين والولايات المتحدة، فقد لا تنحاز إلى جانبها.
كل هذا يحمل دروسًا مهمة للمسؤولين الأمريكيين. فهم يريدون التحوط ضد الصين باستخدام "ساحات صغيرة وأسوار عالية". ولكن في غياب فهم واضح للتنازلات الناجمة عن الرسوم الجمركية والقيود، يكمن الخطر الحقيقي في أن كل مخاوف أمنية تؤدي إلى ساحات أكبر وأسوار أعلى.
وتظل الفوائد حتى الآن بعيدة المنال، كما أن التكاليف التي فاقت التوقعات أبرزت الحاجة إلى استراتيجية أفضل.
علاوة على ذلك، كلما كان النهج أكثر انتقائية، زادت فرص إقناع الشركاء التجاريين بتقليل اعتمادهم على الصين في المجالات المهمة حقًا. وإلا، فإن القضاء على المخاطر سيجعل العالم أكثر خطورة.
[إعلان 2]
مصدر




![[صورة] اكتشف تجارب فريدة في أول مهرجان ثقافي عالمي](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)
































![[صورة] الأمين العام يحضر العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)





























![[صورة] الأمين العام يحضر الذكرى الثمانين لليوم التقليدي للقوات المسلحة للمنطقة العسكرية الرابعة](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/12/1760265970415_image.jpeg)











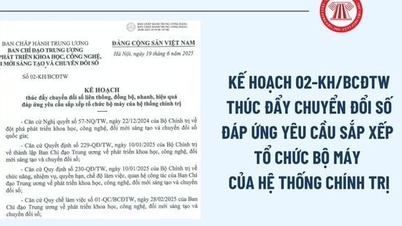


























تعليق (0)